تحميل كتاب "المستدرك
على الصحيحين"
للحاكم النيسابوري، (ط: الميمان) pdf
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكتاب: الكتاب: المستدرك على الصحيحين
المؤلف: أبو عبد
الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (321 - 405 هـ).
المحقق: جماعة
فوق 60 محققا !
الناشر: دارالميمان للنشر والتوزيع- الحجاز- مصر .
سنة النشر: 1435 هـ
- 2014 م
السعر: 7000
جنيه
رقم الطبعة: 1
عدد
المجلدات: 12
عدد
الصفحات: 6556
الحجم
(بالميجا): 95 ميجا
قلت:
* قام على تحقيقه فريق علمي يزيد على الستين
باحثًا في التراث الشرعي واللغوي بإشراف نخبة من علماء المملكة العربية السعودية
وجمهورية مصر العربية، ويصدر في نشرة علمية محققة على 16 مخطوطًا عتيقًا للكتاب،
يحتوي على مجلد يشمل مقدمة ضافية لأهم القضايا والموضوع
كلام الشيخ البطاطي:
صفحة التحميل (أرشيف مباشر) مفهرس :
وكتب: أبو
عبد الرحمن عمرو بن هيمان الجيزي المصري
المقدمة
الحمد
لله فاتحةِ كل خير، وتمامِ كل نعمة، نحمدُه ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل
عليه، ونسألُه الخيرَ كلَّه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالنا،
مَن يَهده الله فلا مُضلَّ له ومَن يُضللْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا
الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ سيدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه، اللهمَّ صلِّ
وسلِّمْ وزدْ وباركْ عليه وعلى آله وصحبِه وأزواجِه أمهاتِ المؤمنين، ومَن تَبِعهم
بإحسانٍ إلى يومِ الدين.
أما بعد:
فلقد
حَظِيَتْ سُنَّةُ رسولِ اللهِ (ص) باهتمامٍ بالغٍ بحُكْمِ أنها المصدرُ الثاني من
مصادرِ التشريعِ الإسلاميّ بعد كتاب الله تعالى، لها مكانتها وحُجِّيَّتُها
الشرعيةُ بينَ سائر الأدلة.
ومن
ثَمَّ قام العديد من أئمة كل عصر بجمعها وتدوينها في مدونات وتصنيفها في مؤلفات،
كما قامتْ علومٌ كثيرةٌ لخدمةِ نصوص هذه السنة المشرفة - روايةً ودرايةً- مثل علم
طبقات الرجال، وعلم الجرح والتعديل، وعلل الأحاديث، وقواعد التحديث وتمييز المقبول
من المردود من الروايات، وغير ذلك.
ولقد
بيَّن الرسول الكريم (ص) أن أقوالَه وأفعالَه مصدرٌ من مصادرِ التشريعِ، ونَدَبَ
صحابتَه الكِرامَ إلى نقلِها
فقال
(ص): « بَلِّغُوا عني ولو آية».
وقال
(ص) في حجة الوداع: « فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ».
وقال أيضًا: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ
مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى
مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ».
ومن
ناحية أخرى وضع النبي (ص) الضوابط التي تقف أمام أيِّ خطأ أو دخيل في وضعِ تشريعٍ
ما وتعميمِه على المسلمين، فقال (ص): « مَن كَذَب عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار ».
وقال (ص): «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ
كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدِكُم».
وهذا
الوعيد الشديد جعل الصحابة الكِرام ومَن جاء بعدهم من علماء الحديث يَحتاطون
تمامًا في نقل الرواية لدرجة أنهم كانوا يَتَحَرَّزون من نسبة الحديث إليهم دون
تثبت، وما لم تُحَقَّقْ سلسلتُه بصورة دقيقةٍ جدًّا.
أما
المُحَدِّثُون الذين جاءوا بعد ذلك وصَنَّفوا هذه الأحاديث وقاموا بتدوينها، فلم
يُثبتوا في كتبهم ما رَوَوْه إلا بعد تحقيق سلاسل الأسانيدِ وتدقيقِها وفقَ مناهج
علمية ارتكز أساسها على النقل والعقل، الأمر الذي لم يجعل حديثًا واحدًا يَمر على
المسلمين دون المرور بهذه القنوات العلمية المحكمة التي تقوم بعمليات الفرز
والتمحيص للروايات.
وهكذا
في ظلِّ الأسبابِ الإلهيةِ والاحتياطاتِ التي اتخذَها النبي (ص)، تمَّ جمْع
رواياتِ أحاديثِ رسولِ اللهِ (ص) بدقةٍ شديدةٍ لتُصبحَ حُجَّةً شرعيةً بعد كتاب
الله عز وجل.
ويمكنُنا
القولُ بأنَّ سُنَّة النبي (ص) قد بدأ تدوينُها تدوينًا منظَّمًا مع بدايات المائة
الثانية من هجرة النبي (ص)[(9)]، بيد أن هذا القول لا يَعني أن حديث رسول الله (ص)
لم يكتب قبل هذا التاريخ، بل وجِدَتْ بعضُ الصحائفِ المشتملة على عدة من أحاديث
رسول الله (ص) منسوبة لبعض الصحابة؛ كصحيفة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
المسماة بـ « الصادقة »، وصحيفة أبي هريرة رضي الله عنه التي كتبها عنه همام بن
منبه، وعرفت بـ « صحيفة همام »، كما كان عند أسماء بنت عُميس رضي الله عنها (توفيت
بعد 40هـ) صحيفةٌ فيها أحاديث عن رسول الله (ص).
وقد
رصد الدكتور محمد مصطفى الأعظمي عددًا غير قليل من صحابة رسول الله (ص) وتابعيهم
ممن كتبوا صحائفَ ودونوا أحاديثَ عن رسول الله (ص) في القرن الأول والثاني
الهجريين.
على
أن مثل هذه الصحائف التي دُونت قبل التاريخ المذكور لم تكن مرتبة ترتيبًا معينًا،
كالذي عُرف لدى المصنِّفِين بعد ذلك؛ كالترتيب بحسب الأبواب الفقهية، أو الترتيب
بحسب المسانيد، أو الترتيب الألفبائي، أو حسب الأطراف مما هو معروف لدى المختصين
وأرباب هذا الشأن، وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال: «اعلمْ -
عَلَّمَنِي الله وإياك - أن آثارَ النبيِّ (ص) لم تكن في عصر أصحابه وكبار تابعيهم
مدونةً في الجوامع، ولا مرتبةً لأمرين:
أحدهما
: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نُهوا عن ذلك، كما ثَبت في صحيح مسلم ؛ خشيةَ أن
يَختلط بعضُ ذلك بالقرآن العظيم.
وثانيهما
: لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة».
اتَّسعتْ
- بعد ذلك - رقعةُ الدولةِ الإسلاميةِ؛ حيث دَخَل النَّاسُ في دين الله أفواجًا،
وانضم إلى قافلة الموحِّدين شعوبُ الأرض مِن كلِّ حَدَبٍ وصَوْب، فدخل في الإسلام
من العرب والعجم الجمُّ الغفير بتَعددِ اللهجاتِ واختلافِ الألسنِ، وتَبايُنِ
العقولِ.
إلا
أنه قد صاحَب هذا التوسعَ في الدولة الإسلامية نشأةُ الفرق وانتشارُ البِدَع،
وبرزت عوامل كثيرة كان لها أثرٌ بالغ في قِلَّةِ الضبطِ وكثرةِ الخطأ في الرواية،
الأمر الذي حَدَا بعلماء الأمة إلى تدوين السنة النبوية المُشَرَّفَة، ومسَّت
الحاجة إلى الحفاظ عليها خالصةً من الدَّخِيل، مُنَقَّاةً من الكذب والافتراء.
وقد
تزامنت هذه الحاجة إلى تدوين السُّنَّةِ المُشَرَّفَة مع الأمرِ الصادرِ مِن
الخليفةِ العادلِ عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - بتدوين حديث رسول الله (ص)
وتقييده؛ وذلك بعد أن رأى الفُرْقَةَ التي أصابت جماعة المسلمين ودبت في صفوفهم،
وما حَدَث لكثير من رواة الحديث وأتباعهم من موت أو قتل في الأحداث التي دارت
رحاها في القرن الأول الهجري.
وقد
ظل الخليفة عمر بن عبد العزيز يستخير الله تعالى أربعين يومًا في تدوين الحديث،
وخار الله له، فأذن لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في التدوين، فدوَّن ما كان
يحفظه في كتاب بعث به إلى الأمصار، وكان أبو بكر هذا قاضيًا وواليًا على
المدينة[(17)]، قال الإمام السيوطي[(18)]:
أَوَّلُ
جامِعِ الحديثِ والأَثَرْ
اِبْنُ
شِهابٍ آمِرًا لَهُ عُمَرْ
فقد
كتب ذلك الإمام العادل إلى أبي بكر بن حزم قائلاً: «انظر ما كان من حديث رسول الله
(ص) فاكتبه؛ فإني خفت دروس[(19)] العلم وذهاب العلماء، ولا تَقبلْ إلا حديث النبي
(ص)، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يَعلمَ مَن لا يَعْلمُ؛ فإن العلم لا يَهلِك حتى
يكونَ سرًّا»[(20)].
وقد
تُوفي عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - قبل أن يبعث إليه أبو بكر بما كتبه،
وكان عمر قد كتب بمثل ذلك أيضًا إلى أهل الآفاق وأمرهم بالنظر في حديث رسول الله
(ص) وجمعه[(21)].
وقد
انْبَرى العلماء من أهل السنة مستجيبين لهذا النداء الجَلَل الذي صادَف في قلوبِهم
ميلاً وفي نفوسِهم رغبة ابتغاءً للثواب الجزيل، فنشطوا لجمع الحديث النبوي الشريف،
والذي زُفَّتْ بُشْرياتُه الأولى بما صنعه أبو بكر بن حزم الأنصاري، وابن شهاب
الزهري، على نحو ما أشير إليه.
وقد
جاء بعد هذين الإمامين رجالٌ جمعوا كتبًا على النهجِ الذي سار عليه هذان الإمامان،
أمثال: ابن جريج بمكة، وابن إسحاق ومالك بن أنس بالمدينة، والربيع ابن صبيح وسعيد
بن أبي عروبة وحماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، والأوزاعي بالشام،
وهشيم بواسط، ومعمر باليمن، وجرير بن عبد الحميد بالرّي، وابن المبارك بخراسان.
يقول
الحافظ ابن حجر: «ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوينُ الآثار وتبويب الأخبار؛
لمّا انتشر العلماء في الأمصار وكَثُر الابتداعُ من الخوارج والروافض ومنكري
الأقدار، فأوّل مَن جمع ذلك الربيع بن صبيح، وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، وكانوا
يُصنِّفون كل باب على حِدَةٍ، إلى أن قام كبارُ أهلِ الطبقةِ الثالثةِ فدَوَّنوا
الأحكام، فصنف الإمام مالك الموطأ ، وتوخَّى فيه القوي من حديث أهل الحجاز، ومزَجه
بأقوالِ الصحابةِ وفتاوى التابعين ومَن بعدَهم، وصنّف أبو محمد عبد الملك بن عبد
العزيز بن جريج بمكة، وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي بالشام، وأبو عبد
الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة، وأبو سلمة حماد ابن سلمة بن دينار بالبصرة، ثم
تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم، إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن
يفرد حديث النبي (ص) خاصةً، وذلك على رأس المائتين؛ فصنَّف عبيد الله بن موسى
العبسي الكوفي مسندًا، وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسندًا، وصنّف أسد بن موسى
الأموي مسندًا، وصنَّف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندًا، ثم اقتفى الأئمة بعد
ذلك أثرهم، فقلّ إمام من الحفاظ إلا وصنَّف حديثه على المسانيد؛ كالإمام أحمد بن
حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء، ومنهم من صنّف على
الأبواب، وعلى المسانيد معًا؛ كأبي بكر بن أبي شيبة»[(22)].
وعلى
الرغم من أن التأليف الحديثي آنذاك كان يتجه إلى جَمْعِ الحديث النبوي مَمْزوجًا
بأقوال الصحابة والتابعين - كما قال الحافظ- إلا أن هؤلاء العلماء والمُحَدِّثين
الأفذاذ قد مهّدوا الطريق لمن جاء بعدهم من الذين جمعوا بين كونهم محدِّثين
ومصنفين؛ كالإمام أحمد بن حنبل (ت 241هـ) ذلك الرجل الذي نَصَر الله به السُّنَّة،
فخالف القائلين بخلق القرآن، وناله من جرَّاء ذلك كثير من العنت والاضطهاد؛ يقول
ابن خلكان: «ودعي إلى القول بخلق القرآن... فلم يجب، فضُرب وحُبس وهو مصرٌّ على
الامتناع، وكان ضَرْبُه في العشر الأخير من شهر رمضان، سنة عشرين ومائتين»[(23)].
وقد
ترك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه - حصادًا هائلاً من الأحاديث المسندة عن
رسول الله (ص) في كتابه «المسند» الذي يشمل أربعين ألف حديث، منها عشرة آلاف
مكررة، وجمع الأحاديث التي تمدح العلويين والأمويين، ولم يَخشَ في ذلك بَطْشَ
العباسيين الذين تَغَلَّبوا على الأمويين وصاروا في سُدَّةِ الحكم، ويتفق منهجه مع
منهج الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه من حيث اعتماده على الحديث، الأمر الذي جعل
البعض يعتبره محدثًا أكثر منه فقيهًا[(24)].
وقد
أخذ عن الإمام أحمد بن حنبل الإمام أبو عبد الله البخاري، رضي الله عنه، ذلك الرجل
الذي طَمح في أن يَجمع دُستورًا صحيحًا للمسلمين بعد كتاب الله، يكون نبراسًا
وهاديًا ومرشدًا في العبادات والمعاملات وسائر شئون الحياة ومناحيها على المنهاج
النبوي الشريف.
وفي
أيامِه بدأتْ أساليب جمع الحديث الشريف وترتيبه تأخذ مكانتَها في الدقة وشدة
التحري ومتانة التوثيق، وكان البخاري مُحَدِّثًا ناقدًا وله نظر ثاقب دقيق في فقه
الحديث، وقد تفوَّق على مَن سَبَقَه من المحدِّثين؛ فلم يكتفِ بجمعِ أحاديثِ
البلادِ التي نشأ فيها، بل تنقَّل في طول البلاد وعرضها لجمع الحديث؛ حتى إن
رحلاتِه العلميةَ قد استغرقتْ ست عشرة سنة[(25)].
أراد
البخاري أنْ يَجْمعَ هذا الدستورَ النبويَّ الشريفَ في صورةٍ ليست مسندةً عن رسول
الله (ص) فَحَسْب، بل تَجْمع إلى هذا السند الخلوَّ -في نظره واجتهاده- من الشذوذِ
والعلل، وتحقق الصحةَ والدقة المتناهية في نقل الأحاديث وقبول الروايات - روايةً
ودرايةً - عن رسول الله (ص).
وعلى
نفس النَّهْجِ من الدقَّة والتتبّع والتحقيق في قَبُول الرواياتِ ونَقْدِ
الأحاديثِ سار الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القُشَيري (204 - 261 هـ/820 -
875 م) - الذي ولد بنيسابور، ورَحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق - في أَشْهَرِ
كتبِه الذي جمع فيه اثني عشر ألف حديثٍ، كَتَبها في خمس عشرة سنة، والتزم فيها
الصحة، حسب نظره واجتهاده، فصار كتابه أحد الصحيحين المُعَوَّل عليهما عند جمهور
الأمة وتلقيهما بالقبول[(26)]، حتى «اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد
القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول »[(27)].
يقول
الخطيب البغدادي: «إنما قفا مسلمٌ طريقَ البخاريِّ ونظر في علمه وحذا حذوه، ولما
ورد البخاري نيسابور في آخر أمره لازمه مسلمٌ وأدام الاختلاف إليه..»[(28)].
وقال
أبو حامد أحمد بن حمدون القصار: «سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل
البخاري فقبَّل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبِّلَ رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد
المحدثين وطبيب الحديث في علله»[(29)].
لقد
أَثبتَ الإمامان البخاري ومسلم في كتابيهما من الأحاديث ما قَطَعا بصحتِه، وثَبت
عندهما نقلُه وتوثيقُه حتى احتلاّ مكانةً عاليةً لدى علماء الأمة على النحو المشار
إليه، واكتسبا أهميةً تشريعيةً للأمةِ عبَّر عنها كثير من العلماء؛ فقد قال الحافظ
ابن الصلاح: (جميع ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم
النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه؛ وذلك لأن
الأمة تلقّت ذلك بالقبول، سوى مَن لا يُعْتَدُّ بخلافه ووِفَاقِه في الإجماع)[(30)].
ونقل
شيخ الإسلام سراج الدين البُلقيني (المتوفى 805هـ) أن هذا مذهب جماعات من
الأصوليين والفقهاء، ثم قال ما نصه: (وأهل الحديث قاطبةً، ومذهب السلف عامّة أنهم
يقطعون بالحديث الذي تلقّته الأمة بالقبول)[(31)].
ولأهمية
هذين الكتابين قامت على خدمتهما العديد من المؤلفات، سواء بالشرح، أو الاختصار، أو
استخراج ما بهما من فوائد في شتى فروع العلم والمعرفة.
أما
بالنسبة لصحيح البخاري : فقد ذكر حاجي خليفة اثنين وثمانين شرحًا له ما بين شرح مختصر
وآخر مطوّل[(32)]. كما لقي هذا الكتاب عناية كبرى في مجالات كثيرة؛ حيث كان محط
أنظار العلماء والدارسين؛ فمنهم من ترجم لرجاله، ومنهم من قام بشرح تراجمه
وعناوينه، ومنهم من قام بترتيب أحاديثه بحسب ترتيب الرواة على حروف الهجاء، ومنهم
من شرح أحاديثه سندًا ومتنًا كما أسلفنا[(33)].
وفيما
يتعلق بصحيح مسلم : فقد لقي هو الآخر عنايةً كبيرةً من العلماء والدارسين؛ حيث قام
على ترجمة رجاله غير واحد من العلماء وقام بشرحه سندًا ومتنًا عددٌ من العلماء؛
كالمازري وعياض والنووي والقرطبي والسيوطي، كما عمل على اختصاره أكثر من عالم؛
كمختصر الإسفراييني، ومختصر المنذري، ولدراسة رجاله ألف أبو بكر الأصفهاني،
المعروف بابن منجويه المتوفى 428هـ، رجال صحيح مسلم[(34)].
ومن
الفنون التي قامت على خدمة الصحيحين ما عرف باسم: المستخرجات والمستدركات :
أما
المستخرج : فهو مصطلح مشتق من الاستخراج، وهو أن يأتي المصنف إلى كتاب، فيُخَرِّج
أحاديثَ هذا الكتاب بأسانيد لنفسه عن شيوخه فمن فوقهم من طريق غير طريق صاحب
الكتاب، فيجتمع معه في شيخه، أو مَن فوقه.
يقول
السيوطي: «وموضوع المستخرج - كما قال العراقي - أن يأتي المصنف إلى الكتاب
فيُخَرِّج أحاديثَه بأسانيدَ لنفسِه مِن غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه
أو مَن فوقه. قال شيخ الإسلام: وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندًا يوصِّله
إلى الأقرب إلا لعذر؛ من عُلُوٍّ أو زيادة مهمة، قال: ولذلك يقول أبو عوانة في
مستخرجه على مسلم بعد أن يسوق طرق مسلم كلها: من هنا لمُخَرِّجِه. ثم يَسوق
أسانيدَ يجتمع فيها مع مسلم في شيخه أو فيمن فوق، وربما قال: من هنا لم يخرجاه.
قال: ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلمًا؛ فإني استقريت صنيعه في ذلك فوجدتُه إنما
يعني مسلمًا وأبا الفضل أحمد بن سلمة؛ فإنه كان قرين مسلم وصنَّف مثل مسلم، وربما
أسقط المستخرج أحاديث لم يجد لها بها سندًا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب
الكتاب»[(35)].
ومن
المستخرجات على صحيح الإمام البخاري : مستخرج الإسماعيلي (ت 371)، ومستخرج
الغطريفي (ت 377)، ومستخرج ابن أبي ذهل (378)، ومستخرج البرقاني (ت 425)، ومستخرج
ابن مردويه (ت 416).
أما
صحيح الإمام مسلم بن حجاج ، فقد حظي بمجموعة من المستخرجات عليه، منها: مستخرج
الحافظ أحمد بن سلمة البزار (286هـ)، ومستخرج أبي بكر النيسابوري (286هـ)، ومستخرج
أبي عوانة الإسفراييني (316هـ)، ومستخرج أبي بكر الجوزقاني (388هـ)، ومستخرج أبي نعيم
الأصبهاني.
ومن
العلماء مَن استخرج عليهما معًا في كتاب واحد، كصنيع الحافظ أبي بكر ابن عبدان
الشيرازي (388هـ)[(36)].
وأما
المستدرك : فهو نوع من التأليف يقوم فيه صاحبه باستدراك ما فات مؤلِّفا آخر في
كتاب له على شرطه، على نحو ما سنشير إليه عند دراستنا لتحرير اسم الكتاب إن شاء
الله[(37)].
ويأتي
في طليعة هذه الكتب التي أُلِّفت لاستدراك أحاديث على الشيخين على شرطهما أو شرط
أحدهما ولم يُخَرِّجاه، كتاب الحافظ أبي الحسين علي بن عمر الدارقطني البغدادي (ت
385هـ) الإلزامات؛ حيث جمع فيه سبعين حديثًا مرتبة على مسانيد الصحابة رأى أنها
على شرطيهما أو شرط أحدهما، وألزمهما ذكرها[(38)].
ومن
أشهر كتب المستدركات : الكتاب الذي نقدمه اليوم للقارئ الكريم، وهو كتاب أبي عبد
الله الحاكم النيسابوري المسمى: « المستدرك على الصحيحين » الذي أملاه الحاكم على
طلاب علمه بقصد خدمة السنة النبوية المباركة، والدفاع عنها أمام منكريها والطاعنين
فيها؛ حيث ظهر في عصره جماعة من المبتدعة يذمّون رواة الآثار ويدّعون أن جميع ما
يصح من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث التي هي مجموع أحاديث الصحيحين تقريبًا،
فألحّ عليه أهل العلم في عصره للرد على هؤلاء المبتدعة؛ لأنهم يرون للحاكم مكانة
عظيمة في نفوسهم، وأنه مشهود له بقوة الحافظة والإتقان، وبمعرفة علم الحديث بشكل
تدل عليه عبارات العلماء الذين أطروه وأثنوا عليه، على نحو ما سنتعرض له عند
الترجمة له رحمه الله.
والبخاري
ومسلم لم يجمعا كل الأحاديث الصحيحة، ولم يزعُما ذلك، ومن ثَمَّ اجتهد الحاكم - مع
مَن اجتهد من العلماء - قَدْرَ علمه ومعرفته في إضافة أحاديث أخرى تساوي أو تشابه
أحاديث الصحيحين في الصحة والضبط، لكنها ليست فيهما أو في أحدهما.
قال
ابن الصلاح: «واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح
على ما في الصحيحين، وجَمَع ذلك في كتاب سمَّاه المستدرك، أودعه ما ليس في واحد من
الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين وقد أخرجا عن رواته في كتابيهما»[(39)].
لقد
ألَّف الحاكمُ مستدركَه هذا، فملأ الدنيا وشغل الناس، واهتمَّ به العلماء في شرق
العالم الإسلامي وغربه، ما بين مادح وقادح؛ لما لتقريرات الحاكم من أهمية بالغة
لدى المحدِّثين. فلقد انتخب على خلق كثير وجَرَّح وعَدَّل وقُبل قولُه في ذلك لسعة
علمه ومعرفته بالعلل والصحيح والسقيم[(40)]. بل ذكره الذهبي في رسالته: من يعتمد
قوله في الجرح والتعديل[(41)] في الطبقة العاشرة.
وعلى
الرغم من هذه الأهمية الكبرى التي حظي بها هذا الكتاب، وأهمية أحكامه في الأوساط
المعنية بعلم الحديث الشريف، والتي هي مستمدةٌ من أهمية الصحيحين، فإنه لم يلقَ من
العناية بتحقيق نصوصه ما يليقُ بهذه الأهمية منذ طبعاته الأولى، ربما كان لظروف
خارجةٍ عن طَوْقِ مَنْ تَصَدَّوا لإخراجه؛ من نُدرة مخطوطاتِه، وعدم اكتمالِ
الموجود منها، أو رداءةِ البعض الآخر، وغيرِ ذلك من المشكلات التي يَعرفها أهل
الاختصاص وأشار إلى عدد منها أصحاب طبعته الهندية، كما سنتناوله تفصيلاً في
دراستنا للكتاب.
ومن
هنا، وشعورًا منا بدورنا في خدمة السنة النبوية، رأينا أن إخراج هذا الكتاب في
صورة محققة تحقيقًا لائقًا بمكانة الكتاب ومكانة مؤلّفه مما يحتِّمُه علينا واجبنا
تجاه أمتنا، لا سيما وقد عاهدنا الله ألا نُصْدِر إلا النافعَ من كتب العلم،
وتجنّب العمل التجاري الذي يبتغي به البعضُ الربحَ السريعَ على حساب العلم
والجناية عليه.
ولقد
كان من الضروري تحقيق هذا السِّفر العظيم الذي يُعدُّ كَنزًا من كنوز التراث
الإسلامي، وتخليصه مما اعتراه من تصحيفات وتحريفات وسقط وخلط بين الروايات التي لم
تخل منها طبعة من طبعاته الحالية، كما أن اجتماع ستة عشر مخطوطًا لأصل الكتاب -
بعد بحث دام سنين طويلة في أرجاء دور ومكتبات المخطوطات المختلفة - كان حافزًا
قويًّا لتحقيقه، وتقديمه في الصورة التي تليق به.
وإننا
نرجو أن نكون قد وفِّقنا لتحقيق رغبات القراء وطلبة العلوم الشرعية من استدراك
لبعض الملاحظات على الطبعات المختلفة لكتاب المستدرك والتي لم تنل قدرًا كبيرًا من
الرعاية والاهتمام.
إن
هذا الكتاب هو باكورة الثمار المنتظرة لمشروع جامع السنة النبوية المشرفة، ذلك
المشروع الإلكتروني الضخم الذي تعمل شركة الدار العربية منذ عام 2002م على تصميمه
وإنجازه، وهو يضم طائفة كبيرة من كنوز السنة النبوية المسندة التي ننتوي إخراجها
مفردة وتقديمها للجمهور تباعًا بصورة مستقلة عن البرنامج المذكور.
والحق
أن إخراج هذه الموسوعة العلمية الكبيرة يحتاج إلى النية الصالحة وتضافر الجهود
وتكاتفها وتوافر الإمكانات المالية اللازمة، فمن الصعوبة بمكان خروج مثل هذا العمل
على النحو المشار إليه بجهد فردي أعزل، فكم من الأعمال العلمية الكبيرة يتعثر
القيام بها نتيجة لعدم توافر المتطلبات والوسائل المعينة.
ولقد
تطلب تحقيق هذا الكتاب جُهودًا عظيمةً لكي يتحقق ذلك الحُلم الذي داعب خيالَ
الكثيرين من مطالعي التراث النبوي الشريف في أن يَرَوْا كتاب « المستدرك على
الصحيحين » محققًا تحقيقًا علميًّا يتسم بالدقة والتحري والتوثيق وتذليل ما به من
صعوبات، وحل ما به من مشكلات، وتفسير ما اعتراه من غموض، وتنقية مادته من الدخيل،
وقد كان من توفيق الله أن يتم ذلك بتعاون لجنة من الباحثين المتخصصين في مشروع
جامع السنة النبوية بالدار العربية تحت رعاية ثلة من العلماء والمتخصصين أمثال
سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا، والأستاذ
الدكتور علي بن عبد الله الصياح أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الملك سعود اللذين
تحمسا حماسًا غير عادي بالرعاية على تحقيق هذا السفر الكبير.
ولقد
منَّ الله تعالى ووفَّق وأعان على العزم والبدء في تحقيق هذه الموسوعة وإخراجها
لطلاب العلم والمعرفة ومؤسسات العلم والثقافة والحضارة، وكان من أقوى الأسباب في
إخراج هذه الموسوعة أن نشط ذلك الصرح الثقافي بدار الميمان، وسعى لها سعيها بتوفير
الإمكانات المالية والخبرات العلمية لتحقيقها.
إننا
نتوجه بخالص الشكر وعميق التحية لهؤلاء العلماء الأجلاء وأصحاب هذه الجهود الكبيرة
في إنجاز هذا المشروع العظيم طوال السنوات الماضية، ولا نستطيع أن نغفل اللواء
دكتور محمد رفعت الحفني مدير عام الشركة بالقاهرة الذي انتقل إلى جوار ربه قبل أن
يرى ثمرة جهوده في مشروعات جامع السنة، فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
كما
نزجي أسمى آيات التقدير للشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي مدير إدارة المجموعات
الخاصة بمركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية، فقد طوقنا بجميله الذي نذكره
له بالخير، فقد قام بالبحث عن مخطوطات الكتاب وزودنا بعدد من النسخ الخطية التي لم
نتمكن من الحصول عليها.
والشكر
موصول إلى سعادة الدكتور خالد بن منصور الدريس أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الملك
سعود بالرياض لمعاونته الجادة خلال سنوات العمل في هذا المشروع.
ونحن
حين نقدم هذه النشرة من كتاب المستدرك، فإننا نتوجه بالشكر إلى كل من أسهم في
إخراج هذا العمل، ولا سيما فريق الباحثين الشرعيين واللغويين بشركة الدار العربية
الذين بذلوا جهودًا مضنية كي يخرج هذا العمل بهذه الصورة القشيبة، وسيلمس القارئ
بنفسه مدى الجهد الذي بُذل من جانبهم بسخاء ونُبْل في سبيل ضبط النص وتحقيقه
وتوثيقه وفق قواعد التحقيق العلمي السديد.
كما
نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن، وأن يجعله إسهامًا
فكريًّا، يُسدِّد من خُطَى أمّتنا على نبيها أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وقبل
أن نعرض النص المحقق لكتاب المستدرك نستميح القارئ عذرًا في عرض مقدمة وجيزة،
كإجراء تكميلي لتحقيق هذا السفر، وتتكون هذه المقدمة من ستة فصول على النحو التالي:
الفصل
الأول: دراسة عن موطن الحاكم وعصره[(42)].
وقد
رأينا أن ينقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث على النحو التالي:
المبحث
الأول: التعريف بنيسابور.
المبحث
الثاني: الحياة السياسية لنيسابور في عصر الحاكم
المبحث
الثالث: الحياة الاجتماعية لنيسابور في عصر الحاكم
المبحث
الرابع: الحياة العلمية والثقافية لنيسابور في عصر الحاكم
الفصل
الثاني: التعريف بالإمام الحاكم
وقد
تم تناوله من خلال ستة مباحث رأينا أنها تتماشى مع الغرض الأصلي من هذا الفصل، وهو
إعطاء صورة موجزة عن حياة الحاكم وسيرته.
المبحث
الأول: سيرته الشخصية والأسرية
المبحث
الثاني: صفاته وسماته الخُلُقية
المبحث
الثالث: حياته العلمية
المبحث
الرابع: مذهبه الفقهي والعقائدي
المبحث
الخامس: مكانته وثناء العلماء عليه
المبحث
السادس: مكانته السياسية ومناصبه في الدولة
أما
الفصل الثالث: دراسة كتاب المستدرك
فقد
تناولنا من خلاله المباحث الثمانية الآتية:
المبحث
الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى مؤلفه
المبحث
الثاني: سبب تأليف الكتاب
المبحث
الثالث: تاريخ إملاء الحاكم لمستدركه
المبحث
الرابع: المادة العلمية للكتاب ومنهج المؤلف في عرضها
المبحث
الخامس: موارد الحاكم في مستدركه
المبحث
السادس: القيمة العلمية للكتاب
المبحث
السابع: جهود العلماء في خدمة المستدرك
المبحث
الثامن: مآخذ على الكتاب
الفصل
الرابع: منهج الحاكم وشروطه في تصحيح أحاديث المستدرك
وفيه
مبحثان:
المبحث
الأول: المنهج والشروط
المبحث
الثاني: أقسام الحديث في كتاب المستدرك
وفيه
مطلبان:
المطلب
الأول: تمهيد في شروط الشيخين عند الحاكم واختلاف العلماء في تفسير الحاكم
المطلب
الثاني: مدى التزام الحاكم بشروطه ونقد العلماء له
المطلب
الثالث: تفصيل أقسام الأحاديث في كتاب المستدرك
الفصل
الخامس: التعريف بنسخ الكتاب الخطية ومنهج التحقيق والتعليق على النص:
تناولناه
من خلال المباحث التالية:
المبحث
الأول: الطبعات السابقة ومبررات التحقيق
المبحث
الثاني: توصيف النسخ الخطية ونماذج منها
المبحث
الثالث: منهجنا في تحقيق الكتاب
وإننا
إذ نحمد الله تعالى أن هدانا لهذا، فنسأله سبحانه أن يرزقنا الصواب والتوفيق
والشكر له سبحانه وتعالى على ما أعان ويسَّر، ونبتهل إليه عز وجل أن يأخذ بأيدينا
نحو سُبُلِ الخير وشِعاب المعرفة، وأن يُطهر قلوبَنا من زَيْغِ الهوى ورِجْس
الإِحَن؛ للعمل على خدمة هذا الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والله
من وراء القصد
صفحة التحميل (تلجرام) :
وكتب أبو عبد الرحمن عمرو بن هيمان الجيزي
المصري

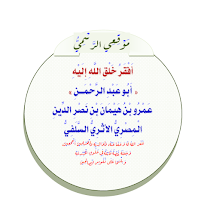
%20%20pdf1.png)